كاتب الموضوع :
lost in memories
المنتدى :
الادباء والكتاب العرب

الفصل السادس
لعرسك لبست بدلتي السوداء.
مدهش هذا اللون. يمكن أن يلبس للأفراح.. وللمآتم!
لماذا اخترت اللون الأسود؟
ربما لأنني يوم أحببتك أصبحت صوفياً، وأصبحتِ أنتِ مذهبي وطريقتي. وربما لأنه لون صمتي.
لكل لون لغته. قرأت يوما أن الأسود صدمة للصبر.
قرأت أيضاً أنه لون يحمل نقيضه. ثم سمعت مرة مصمم أزياء شهيراً، يجيب عن سر لبسه الدائم للأسود قال:
"إنه لون يضع حاجزاً بيني وبين الآخرين".
ويمكن أن أقول لك اليوم الكثير عن ذلك اللون. ولكني سأكتفي بقول مصمم الأزياء هذا.
فقد كنت في ذلك اليوم أريد أن أضع حاجزاً بيني وبين كل الذين سألتقي بهم، كل ذلك الذباب الذي جاء ليحط على مائدة فرحك.
وربما كنت أريد أن أضع حاجزاً بيني وبينك أيضاً.
لبست طقمي الأسود، لأواجه بصمت ثوبك الأبيض، المرشوش باللآلئ والزهور، والذي يقال إنه أعدّ لك خصيصاً في دار أزياء فرنسية..
هل يمكن لرسام أن يختار لونه بحياد؟
وكنت أنيقاً. فللحزن أناقته أيضاً. أكّدت لي المرآة ذلك. ونظرة حسان، الذي استعاد فجأة ثقته بي، وقال بلهجة جزائرية أحبها، وهو يتأملني: "هكذا نحبك آ خالد.. إهلكهم..!".
نظرت إليه.. كدت أقول له شياً.. ولكني صمتّ.
عند الباب المشرع للسيارات، وأفواج القادمين، استقبلني سي الشريف بالأحضان..
- أهلاً سي خالد.. أهلاً.. زارتنا البركة.. يعطيك الصحة اللي جيت.. راك فرحتني اليوم.
اختصرت ذلك الموقف العجيب مرة أخرى في كلمة. قلت:
- كل شيء مبروك..
وضعت قناع الفرح على وجهي. وحاولت أن أحتفظ به طوال تلك السهرة.
يمتلئ البيت زغاريد. ويمتلئ صدري بدخان السجائر التي أحرقها وتحرقني. يمتلئ قلبي حزناً. ويتعلم وجهي تلقائياً الابتسامات الكاذبة. فأضحك مع الآخرين. أجالس من أعرف ومن لا أعرف. أتحدث في الذي أدري والذي لا أدري. حتى لا أخلو بك لحظة واحدة.. حتى لا أفاجئك داخلي.. فأنهار.
أسلّم على العريس الذي يقبّلني بشوق صديق قديم لم يلتق به منذ مدة:
- هاك جيت للجزائر آ سيدي.. كان موش هاذا العرس.. ما كناش شفناك!
أحاول أن أنسى أنني أتحدث لزوجك، لرجل يتحدث إليّ مجاملة على عجل، وهو يفكر ربما في اللحظة التي سينفرد فيها بك في آخر الليل..
أتأمل سيجاره الذي اختاره أطول للمناسبة.. بدلته الزرقاء الحريرية التي يلبسها _أو تلبسه_ بأناقة من تعوّد على الحرير. أحاول ألا أتوقف عند جسده. أحاول ألا أتذكر. أتلهّى بالنظر إلى وجوه الحاضرين.
وتطلّين..
تدخلين في موكب نسائي، يحترف البهجة والفرح، كما أحترف أنا الرسم والحزن.
أراك لأول مرة، بعد كل أشهر الغيبة تلك، تمرين قريبة وبعيدة، كنجمة هاربة. تسيرين.. مثقلة الأثواب والخطى، وسط الزغاريد ودقّات البندير. وأغنية تستفزّ ذاكرتي، وتعود بي طفلاً أركض في بيوت قسنطينة القديمة. في مواكب نسائية أخرى.. خلف عروس أخرى.. لم أكن أعرف عنها شيئاً يومذاك.
آه كم كنت أحب تلك الأغاني التي كانت تزفّ بها العرائس، والتي كانت تطربني دون أن أفهمها. وإذا بها اليوم تبكيني!
"شرّعي الباب يا أم العروس.." يقال إن العرائس يبكين دائماً عند سماع هذه الأغنية.
تراك بكيت يومها؟
كانت عيناك بعيدتين.. يفصلني عنهما ضباب دمعي وحشد الحضور. فعدلت عن السؤال.
اكتفيت بتأمّلك، في دورك الأخير.
ها أنت ذي تتقدّمين كأميرة أسطورية، مغرية شهية، محاطة بنظرات الانبهار والإعجاب.. مرتبكة.. مربكة، بسيطة.. مكابرة.
ها أنت ذي، يشتهيك كل رجل في سرّه كالعادة.. تحسدك كل النساء حولك كالعادة..
وها أنذا _ كالعادة_ أواصل ذهولي أمامك.
وها هوذا "الفرقاني".. كالعادة.. يغنّي لأصحاب النجوم والكراسي الأمامية.
يصبح صوته أجمل، وكمنجته أقوى عندما يزفّ الوجهاء وأصحاب القرار والنجوم الكثيرة.
تعلو أصوات الآلات الموسيقية.. ويرتفع غناء الجوقة في صوتٍ واحد لترحب بالعريس:
"يا ديني ما أحلالي عِرسو.. بالعوادة..
الله لا يقطعلو عادة..
وانخاف عليه.. خمسة. والخميس عليه"
تعلو الزغاريد.. وتتساقط الأوراق النقدية.
ما أقوى الحناجر المشتراة. وما أكرم الأيدي التي تدفع كما تقبض على عجل!
ها هم هنا..
كانوا هنا جميعهم.. كالعادة.
أصحاب البطون المنتفخة.. والسجائر الكوبية.. والبدلات التي تلبس على أكثر من وجه.
أصحاب كل عهد وكل زمن.. أصحاب الحقائب الدبلوماسية، أصحاب المهمات المشبوهة، أصحاب السعادة وأصحاب التعاسة، وأصحاب الماضي المجهول.
ها هم هنا..
وزراء سابقون.. ومشاريع وزراء. سرّاق سابقون.. ومشاريع سرّاق. مديرون وصوليون.. ووصوليون يبحثون عن إدارة. مخبرون سابقون.. وعسكر متنكّرون في ثياب وزارية.
ها هم هنا..
أصحاب النظريات الثورية، والكسب السريع. أصحاب العقول الفارغة، والفيلات الشاهقة، والمجالس التي يتحدث فيها المفرد بصيغة الجمع.
ها هم هنا.. مجتمعون دائماً كأسماك القرش. ملتفون دائماً حول الولائم المشبوهة..
أعرفهم وأتجاهل معظمهم "ما تقول أنا.. حتى يموت كبار الحارة!"
أعرفهم وأشفق عليهم.
ما أتعسهم في غناهم وفي فقرهم. في علمهم وفي جهلهم. في صعودهم السريع.. وفي انحدارهم المفجع!
ما أتعسهم، في ذلك اليوم الذي لن يمدّ فيه أحد يده حتى لمصافحتهم.
في انتظار ذلك.. هذا العرس عرسهم. فليأكلوا وليطربوا. وليرشقوا الوراق النقدية. وليستمعوا للفرقاني يردد كما في كل عرس قسنطيني أغنية "صالح باي".
تلك التي مازالت منذ قرنين تُغنّى للعبرة، لتذكّر أهل هذه المدينة بفجيعة (صالح باي) وخدعة الحكم والجاه الذي لا يدوم لأحد..
والتي أصبحت تُغنّى اليوم بحكم العادة للطرب دون أن تستوقف كلماتها أحداً..
كانوا سلاطين ووزراء *** ماتوا وقبلنا عزاهمْ
نالوا من المال كُثرةْ *** لا عزّهم.. لا غناهُمْ
قالوا العرب قالوا *** ما نعطيوْ صالح ولا مالُو.."
أتذكر وأنا أستمع لهذه الكلمات، أغنية عصرية أخرى وصلتني كلماتها من مذياع بموسيقى راقصة.. تتغزّل بصالح آخر "صالح.. يا صالح.. وعينيك عجبوني..".
إيه يا قسنطينة، لكل زمن "صالحه".. ولكن ليس كل "صالح" باياً.. وليس كل حاكم صالحاً!
ها هوذا الوطن الآخر أخيراً أمامي.. أهذا هو الوطن حقاً؟
في كل مجلس وجه أعرف عنه الكثير. فأجلس أتأمّلهم، وأستمع لهم يشكون ويتذمّرون.
لا أحد سعيد منهم حسب ما يبدو.
المدهش أنهم هم دائماً الذين يبادرونك بالشكوى، وبنقد الأوضاع.. وشتم الوطن.
عجيبة هذه الظاهرة!
كأنهم لم يركضوا جميعاً خلف مناصبهم زحفاً على كل شيء. كأنهم ليسوا جزءاً من قذارة الوطن. كأنهم ليسوا سبباً في ما حلّ به من كوارث..
أسلِّم على (سي مصطفى). لقد أصبح وزيراً منذ ذلك اليوم الذي زارني فيه ليشتري مني لوحة. ورفضت أن أبيعه إياها.
لقد نجحت تكهّنات (سي الشريف) إذن، فقد راهن على حصان رابح..
أسأله مجاملة:
- واش راك سي مصطفى؟
فيبدأ دون مقدمات بالشكوى:
- رانا غارقين في المشاكل.. على بالك..!
تحضرني وقتها، مصادفة، مقولة لديغول: "ليس من حق وزير أن يشكو.. فلا أحد أجبره على أن يكون وزيراً!".
أحتفظ بها لنفسي وأقول له فقط..
- إيه.. على بالي..
نعم.. كنت (على بالي..) بتلك المبالغ الهائلة التي تقاضاها في كندا كعمولة لتجديد معدّات إحدى الشركات الوطنية الكبرى. ولكنني كنت أخجل أن أقول له ذلك، لأنني أدري أن الذين سبقوه إلى ذلك المنصب.. لم يفعلوا أحسن منه.
اكتفيت فقط بالاستماع إليه وهو يشكو، بطريقة تثير شفقة أي مواطن مسكين..
بينما كان حسان مشغولاً عني بالحديث مع صديق قديم.. كان أستاذاً للعربية.. قبل أن يصبح فجأة.. سفيراً في دولة عربية!
كيف حدث ذلك؟
يقال إنه ردّ دين.. وقضية "تركة" وصداقة قديمة تجمع ذلك الأستاذ بوالد إحدى الشخصيات.. وأنها ليست "الحالة الدبلوماسية" الوحيدة!
مثل (سي حسين) الذي أعرفه جيداً والذي كان مدير إحدى المؤسسات الثقافية، يوم كنت أنا مديراً للنشر. وإذا به بين ليلة وضحاها يعيّن سفيراً في الخارج.. بعدما طلعت رائحته في الداخل. فتكفلوا بلفّه بضعة أشهر وبعثه إلى الخارج مع كل التشريفات الدبلوماسية خلف علم الجزائر!
ها هوذا اليوم هنا.. في جوّه الطبيعي.
لقد استدعي إثر قضية احتيال وتلاعب بأموال الدولة في الخارج، ليعاد دون ضجيج إلى وظيفة حزبية.. ولكن على كرسي جانبي هذه المرة.
هنالك دائماً في هذه الحالات.. سلة مهملات شرفيّة!
في مجلس آخر، مازال أحدهم ينظّر ويتحدث وكأنه مفكّر الثورة وكل ما سيليها من ثورات. وإحدى ثورات هذا الشخص.. أنه وصل إلى الصفوف الأمامية في ظروف مشبوهة، بعدما تفرّغ لتقديم طالباته إلى مسؤول عجوز مولع بالفتيات الصغيرات..
هذا هو الوطن..
وها هو عرسك الذي دعوتني إليه. إنه "السيرك عمّار".. سيرك لا مكان فيه إلا للمهرّجين، ولمن يحترفون الألعاب البهلوانية.. والقفز على المراحل.. والقفز على الرقاب.. والقفز على القِيَم.
سيرك يضحك فيه حفنة على ذقون الناس، ويروّض فيه شعب بأكمله على الغباء.
فكم كان ناصر محقاً عندما لم يحضر هذا الكرنفال!
كنت أدري بحدسٍ ما أنه لن يحضر.. ولكن أين هو الآن.؟
تراه مازال يصلي في ذلك المسجد.. لكي لا يلتقي بهم. وهل تغيّر صلاته.. أو يغيّر سكري شيئاً؟
آه يا ناصر! كفّ عن الصلاة يا ابني. لقد أصبحوا يصلّون أيضاً ويلبسون ثياب التقوى. كفّ عن الصلاة.. وتعال نفكّر قليلاً. فأثناء ذلك ها هوذا الذباب يحطّ على كل شيء، والجراد يلتهم هذه الوليمة.
كلما تقدم الليل، تقدم الحزن بي، وتقدم بهم الطرب. وانهطل مطر الأوراق النقدية عند أقدام نساء الذوات، المستسلمات لنشوة الرق، على وقع موسيقى أشهر أغنية شعبية..
"إذا صاح الليل وَيْن انباتُو *** فوق فراش حرير ومَخدّاتُو.."
أمان.. أمان..
إيه آ الفرقاني غَنِّ..
لا علاقة لهذه الأغنية بأزمة السكن، كما قد يبدو من الوهلة الأولى. إنها فقط تمجيد لليالي الحمراء والأسرّة الحريرية التي ليست في متناول الجميع.
"ع اللي ماتوا.. يا عين ما تبكيش ع اللي ماتوا.."
أمان.. أمان.
لن أبكي.. ليست هذه ليلة لسي الطاهر.. ولا لزياد.
ليست للشهداء ولا للعشاق. إنها ليلة الصفقات التي يحتفل بها علناً بالموسيقى والزغاريد.
"خارجة من الحمّامْ بالريحيّةْ *** يا لِندراشْ للغير وإلا ليّ.."
أمان.. أمان.
لن أطرح على نفسي هذا السؤال. الآن أعي أنكِ للغير ولستِ لي. تؤكد ذلك الأغنيات، وذلك الموكب الذي يهرب بك، ويرافقك بالزغاريد إلى ليلة حبّك الشرعية.
وعندما تمرّين بي، عندما تمرين.. وأنت تمشين مشية العرائس تلك، أشعر أنكِ تمشين على جسدي، ليس "بالريحيّة" وإنما بقدميك المخضّبتين بالحناء.. وأن خلخالك الذهبي يدّق داخلي، ويعبرني جرساً يوقظ الذاكرة..
قفي..
قسنطينة الأثواب مهلاً! ما هكذا تمرّ القصائد على عجل!
ثوبك المطرّز بخيوط الذهب، والمرشوش بالصكوك الذهبية، معلّقة شعر كتبتها قسنطينة جيلاً بعد آخر على القطيفة العنابي. وحزام الذهب الذي يشد خصرك، لتتدفّقي أنوثة وإغراءً، هو مطلع دهشتي.
هو الصدر والعجز في كل ما قد قيل من شعرٍ عربيّ.
فتمهّلي..
دعيني أحلم أن الزمن توقّف.. وأنك لي. أنا الذي قد أموت دون أن يكون لي عرس، ودون أن تنطلق الزغاريد يوماً من أجلي.
كم أتمنى اليوم لو سرقت كل هذه الحناجر النسائية، لتبارك امتلاكي لك!
لو كنت "خطّاف العرائس" ذلك البطل الخرافي الذي يهرب بالعرائس الجميلات ليلة عرسهنّ، لجئتك أمتطي الريح وفرساً بيضاء.. وخطفتك منهم..
لو كنتِ لي.. لباركتنا هذه المدينة، ولخرج من كل شارع عبرناه وليّ يحرق البخور على طريقنا.. ولكن ما أحزن الليلة.. قسنطينة!
ما أتعس أولياءها الصالحين.. وحدهم جلسوا إلى طاولتي دون سبب واضح.. وحجزوا لذاكرتي الأخرى كرسيّاً أمامياً..
وإذا بي أقضي سهرتي في السلام عليهم واحدا واحدا..
سلاماً يا سيدي راشد..
سلاماً يا سيدي مبروك.. يا سيدي محمد الغراب.. يا سيدي سليمان.. يا سيدي بوعنّابة.. يا سيدي عبد المؤمن.. يا سيدي مسيد.. يا سيدي بومعزة.. يا سيدي جليس..
سلاماً يا من تحكمون شوارع هذه المدينة.. أزقّتها وذاكرتها.
قفوا معي يا أولياء الله.. متعب أنا هذه الليلة.. فلا تتخلوا عني.. أما كان منكم أبي؟
أبي يا "عيساوي" أباً عن جَد؟
أنت الذي كنت في تلك الحلقات المغلقة، في تلك الطقوس الطُرقيّة العجيبة، تغرس في جسدك ذلك السفود الأحمر الملتهب ناراً.. فيتخرق جسدك من طرفٍ إلى آخر، ثم تخرجه دون أن تكون عليه قطرة دم؟
أنت الذي كنت تمرّر حديده الملتهب والمحمّر كقطعة جمر، فينطفئ جمره من لعابك، ولا تحترق.
علّمني الليلة كيف أتعذّب دون أن أنزف.
علّمني كيف أذكر اسمها دون أن يحترق لساني.
علّمني كيف أشفى منها، أنت الذي كنت تردد مع جماعة "عيساوة" في حلقات الجذب والتهويل، وأنت ترقص مأخوذاً باللهب:
"أنا سيدي عيساوي.. يجرح ويداوي.."
من يداويني يا أبي.. من؟
وأحبها..
في هذه الساعة المتأخرة من الألم، أعترف أنني مازلت أحبها.. وأنها لي.
أتحدّى أصحاب البطون المنتفخة.. وذلك صاحب اللحية.. وذلك صاحب الصلعة.. وأولئك أصحاب النجوم التي لا تعدّ.. وكل الذين منحتهم الكثير.. واغتصبوها في حضرتي اليوم.
أتحداهم بنقصي فقط.
بالذراع التي لم تعد ذراعي، بالذاكرة التي سرقوها منّي، بكل ما أخذوه منّا.
أتحداهم أن يحبوها مثلي. لأنني وحدي أحبها دون مقابل.
وأدري أنه في هذه اللحظة، هناك من يرفع عنها ثوبها ذاك على عجل. يخلع عنها صيغتها دون كثير من الاهتمام ويركض نحو جسدها بلهفة رجل في الخمسين يضاجع صبية.
حزني على ذلك الثوب.. حزني عليه.
كم من الأيدي طرّزته، وكم من النساء تناوبن عليه، ليتمتع اليوم برفعه رجل واحد. رجل يلقي به على كرسي كيفما كان، وكأنه ليس ذاكرتنا، كأنه ليس الوطن.
فهل قدر الأوطان أن تعدّها أجيال بأكملها، لينعم بها رجل واحد؟
أتساءل الليلة.. لماذا وحدي تستوقفني كل هذه التفاصيل. وكيف اكتشفت الآن فقط، معنى كل الأشياء التي لم يكن لها معنى من قبل؟
أتراه عُشق هذا الوطن.. أم البعد عنه، هو الذي أعطى الأشياء العادية قداسة لا يشعر بها غير الذي حرم منه؟
ألأن المعايشة اليومية تقتل الحلم وتغتال قداسة الأشياء كان أحد الصحابة ينصح المسلمين بأن يغادروا مكة، حال انتهائهم من مراسيم الحج، حتى تبقى لتلك المدينة رهبتها وقداستها في قلوبهم، وحتى لا تتحول بحكم العادة إلى مدينة عادية يمكن لأي واحدٍ أن يسرق ويزني ويجور فيها دون رهبة؟
إنه ما يحدث لي منذ وطئت قدماي هذه المدينة. وحدي أعاملها كمدينة فوق العادة.
أعامل كل حجر فيها بعشق. أسلم على جسورها جسراً جسراً. أسأل عن أخبار أهلها، عن أوليائها وعن رجالها، واحداً.. واحداً..
أتأملها وهي تمشي، أتألها وهي تصلي، وتزني وتمارس جنونها ولا أحد يفهم جنوني وسرّ تعلّقي بمدينة يحلم الجميع بالهرب منها.
هل أعتب عليهم؟
هل يشعر سكان أثينا أنهم يمشون ويجيئون على ذاكرة التاريخ.. وعلى تراب مشت عليه الآلهة، وأكثر من بطل أسطوري؟
هل يشعر سكان الجيزة في بؤسهم وفقرهم، أنهم يعيشون عند أقدم معجزة، وأن الفراعنة مازالو بينهم، يحكمون مصر بحجرهم وقبورهم؟
وحدهم الغرباء الذين قرأوا تاريخ اليونان والفراعنة، في كتب التاريخ، يعاملون تلك الحجارة بقداسة، ويأتون من أطراف العالم لمجردّ الاقتراب منها.
تراني أطلت المكوث هنا، واقترفت حماقة الاقتراب من الأحلام حتى الاحتراق، وإذا بي يوماً بعد آخر، وخيبة بعد أخرى، أشفى من سلطة اسمها عليّ، وأفرغ من وهمي الجميل.. ولكن ليس دون الم؟
في هذه اللحظة، لا أريد لهذه المدينة أن تكون أكثر من رصاصة رحمة.
ولذا أتقبّل تلك الزغاريد التي انطلقت في ساعة متقدّمة من الفجر، لتبارك قميصك الملطّخ ببراءتك، كآخر طلقة نارية تطلقها في وجهي هذه المدينة، ولكن دون كاتم صوت.. ولا كاتم ضمير. فأتلقاها جامداً.. مذهول النظرات كجثة، بينما أرى حولي من يتسابق للمس قميصك المعروض للفرجة.
ها هم يقدمونك لي، لوحة ملطّخة بالدم، دليلاً على عجزي الآخر. دليلاً على جريمتهم الأخرى.
ولكنني لا أتحرك ولا أحتجّ. ليس من حق مشاهد لمصارعة الثيران، أن يغير منطق الأشياء، وينحاز للثور. وإلا كان عليه أن يبقى في بيته ولا يحضر "كوريدا" خلقت أساساً لتمجيد "الموتادور"!
شيء ما في هذا الجو المشحون بالزغاريد والزينة وموسيقى "الدخلة".. والهتافات أمام ثوب موقّع بالدم، يذكّرني بطقوس الكوريدا. وذلك الثور الذي يعدّون له موتاً جميلاً على وقع موسيقى راقصة يدخل بها الساحة، ويموت على نغمها بسيوفٍ مزيّنة للقتل، مأخوذاً باللون الأحمر.. وبأناقة قاتله!
من منّا الثور؟ أنتِ أم أنا المُصاب بعمى الألوان، والذي لا يرى الآن غير اللون الأحمر.. لون دمك؟
ثور يدور في حلبة حبّك، بكبرياء حيوان لا يهزم إلا خِدعة، ويدري أنه محكوم عليه بالموت المسبق.
الواقع أن دمك هذا يربكني، يحرجني، ويملأني تناقضاً.
أما كنت أتحرق دائماً لمعرفة نهاية قصتك معه، هو الذي أخذك مني، تراه أخذ منك كل شيء؟
سؤال كان يشغلني ويسكنني حد الجنون، منذ ذاك اليوم الذي وضعت فيه (زياد) أمامك. ووضعتك أمام قدرك الآخر.
تراك فتحت له قلاعك المحصّنة، وأذللت أبراجك العالية، واستسلمت لإغراء رجولته؟
تراك تركت طفولتك لي، وأنوثتك له؟
ها هو الجواب يأتيني بعد عام من العذاب. ها هو أخيراً لزج.. طريّ.. أحمر.. ورديّ.. عمره لحظات.
ها هو الجواب كما لم أتوقّعه، مقحماً، محرجاً، فلِمَ الحزن؟
ما الذي يؤلمني الأكثر هذه الليلة.. أن أدري أنني ظلمت زياداً بظني، وأنه مات دون أن يتمتع بك، وأنه في النهاية كان هو الأجدر بك الليلة؟
أم أن تكوني فقط، مدينة فتحت اليوم عنوة بأقدام العسكر، ككل مدينة عربية؟
ما الذي يزعجني أكثر الليلة؟ أن أكون قد عرفت لغزك أخيراً، أم كوني أدري أنني لن أعرف عنك شيئاً بعد اليوم، ولو تحدّثت إليك عمراً، ولو قرأتك ألف مرة؟
أكنتِ عذراء إذن، وخطاياك حبر على ورق؟
فلماذا أوهمتني إذن بكل تلك الأشياء؟ لماذا أهديتني كتابك وكأنك تهدينني خنجراً للغيرة؟
لماذا علّمتني أن أحبكِ سطراً بعد سطر.. وكذبة بعد أخرى.. وأن أغتصبك على ورق!
فليكن..
عزائي اليوم، أنك من بين كل الخيبات.. كنت خيبتي الأجمل.
***
يسألني حسان: لماذا أنت حزين هذا الصباح؟
أحاول ألا أسأله: ولماذا هو سعيد اليوم؟
أدري أن غياب ناصر ومقاطعته البارحة للعرس، قد عكّر نوعاً ما مزاجه. ولكنه لم يمنعه من أن ينسجم مع أغاني "الفرقاني"، وأن يضحك.. ويحادث كثيراً من الناس الذين لم يلتق بهم من قبل.
كنت ألاحظه. وكنت سعيداً شيئاً ما، لسعادته الساذجة تلك.
كان حسان سعيداً أن تُفتح له أخيراً تلك الأبواب التي قلما تفتح للعامة، وأن يدعى لحضور ذلك العرس الذي يمكنه الآن أن يتحدث عنه في المجالس لأيام؛ ويصفه للآخرين الذين سيلاحقونه بالأسئلة، عن أسماء من حضروا وما قُدِّم من أطباقي.. وما لبست العروس..
ويمكن لزوجته أيضاً أن تنسى أنها استعارت صيغتها والثياب التي حضرت بها العرس من الجيران والأقارب، وتبدأ بدورها في التفاخر على الجميع بما رأته من بذخٍ في ذلك العرس، وكأنها أصبحت فجأة طرفاً فيه، فقط لأنها دعيت للتفرّج على خيرات الآخرين.
قال فجأة:
- إن سي الشريف يدعونا غداً للغداء عنده. لا تنسَ أن تكون في البيت وقت الظهر لنذهب معاً..
قلت له بصوت غائب:
- غداً سأعود إلى باريس.
صاح:
- كيف تعود غداً.. ابقَ معنا أسبوعاً آخر على الأقلّ.. ما الذي ينتظرك هناك؟
حاولت أن أوهمه أن لي بعض الالتزامات، وأنني بدأت أتعب من إقامتي في قسنطينة.
ولكنه راح يلحّ:
- يا أخي عيب.. على الأقل احضر غداء سي الشريف غداً ثم سافر..
أجبته بلهجة قاطعة لم يفهم سببها:
- فرات.. غدوة نروّح.
كان يحلو لي أن أحدّثه بلهجة قسنطينية. كنت أشعر مع كل كلمة ألفظها، أنه قد يمر وقت طويل قبل أن ألفظها مرة أخرى.
قال حسان وكأنه يقنعني بضرورة عدم رفض تلك الدعوة:
- والله سي الشريف ناس ملاح.. مازال برغم منصبه وفيّاً لصداقتنا القديمة. أتدري أن البعض يقول هنا إنه قد يصبح وزيراً. ربما يفرجها الله علينا في ذلك اليوم على يده..
قال حسان هذه الجملة الأخيرة بصوت شبه خافت، وكأنه يقولها لنفسه..
مسكين حسان!
مسكين أخي الذي لم يفرجها الله عليه بعد ذلك. أكان من السذاجة بحيث يجهل أن ذلك العرس هو صفقة لا غير، وأن سي الشريف لا بدّ أن يتلقّى شيئاً ما مقابله. نحن لا نصاهر ضبّاطاً من الدرجة الأولى.. دون نوايا مسبقة.
أما بالنسبة لما يمكن أن يربح حسان من وراء منصب سي الشريف المحتمل.. فمجرد أوهام.
المؤمن يبدأ بنفسه، وقد تمر سنوات قبل أن يصل دور حسان.. وينال بعض ما يطمح إليه من فتات.
سألته مازحاً:
- هل بدأت تحلم أن تصبح أنت أيضاً سفيرا؟
قال وكأن السؤال قد جرحه نوعاً ما:
- يا حسرة يا رجل.. "اللي خطف.. خطف بكري.." أنا لا أريد أكثر من أن أهرب من التعليم، وأن أستلم وظيفة محترمة في أيّة مؤسسة ثقافية أو إعلامية، أية وظيفة أعيش منها أنا وعائلتي حياة شبه عادية.. كيف تريد أن نعيش نحن الثمانية بهذا الدخل؟. أنا عاجز حتى عن أن أشتري سيارة. من أين آتي بالملايين لأشتريها؟. عندما أتذكّر تلك السيارات الفخمة التي كانت مصطفّة أمس في ذلك العرس، أمرض وأفقد شهية التعليم. لقد تعبت من هذه المهنة، أنت لا تشعر بأية مكافأة مادية أو معنوية فيها. لقد تغيّر الزمن الذي "كاد فيه المعلم أن يكون رسولاً".. اليوم حسب تعبير زميل لي "كاد المعلم أن يكون (شيفوناً) وخرقة لا أكثر.
لقد أصبحنا ممسحة للجميع. فالأستاذ يركب الحافلة مع تلاميذه. و "يدزّ" و "يطبّع" مثلهم. ويشتمه الناس أمامهم. ثم يعود مثل زميلي هذا، ليعدّ دروسه ويصحّح الامتحانات في شقّة بغرفتين، يسكنها ثمانية أشخاص وأكثر.
بينما هناك من يملك شقّتين وثلاثاً بحكم وظيفته أو واسطاته.. يمكنه أن يستقبل فيها عشقياته أو يعير مفاتيجها لمن سيفتح له أبواباً أخرى.
صحّة عليك يا خالد.. أنت تعيش بعيدا عن هذه الهموم، في حيّك الراقي بباريس.. ما على بالكش واش صاير في الدنيا.!
آه حسان.. عندما أذكر حديثنا ذلك اليوم، تصبح المرارة غصّة في الحلق، تصبح جرحاً، تصبح دمعا، تصبح ندماً وحسرة.
كان يمكن أن أساعدك أكثر، صحيح.
كنت تقول: "اطلب شيئاً يا خالد مادمت هنا، ألست مجاهداً؟ ألم تفقد ذراعك في هذه الحرب؟ اطلب محلا تجارياً.. اطلب قطعة أرض.. أو شاحنة، إنهم لن يرفضوا لك شيئاً. هذا حقك. وإذا شئت دعه لي لأستفيد منه وأعيش عليه أنا وأولادي.. أنت يحترمونك ويعرفونك، وأما أنا فلا يعرفني أحد. إنه جنون ألا تأخذ حقك من هذا الوطن. إنهم لا يتصدّقون عليك بشيء. أكثر من واحد يحمل شهادة مجاهد وهو لم يقم بشيء في الثورة. أنت تحمل شهادتك على جسدك.."
إيه حسان.. لم تكن تفهم أن هذا هو الفرق الوحيد بيني وبينهم. لم تكن تفهم أنه لم يعد ممكناً اليوم، بعد كل هذه السنوات، وكل هذا العذاب، أن أطأطئ رأسي لأحد.. ولو مقابل أية هبة وطنية.
ربما كنت فعلت هذا بعد الاستقلال. ولكن اليوم مع مرور الزمن، أصبح ذلك مستحيلا.
لم يبق من العمر الكثير أخي. لم يبق من العمر الكثير، لأطأطئ رأسي قبل الموت.
أريد أن أبقى هكذا أمامهم، مغروساً كشوكة في ضميرهم. أريد أن يخجلوا عندما يلتقوا بي، أن يطأطئوا هم رؤوسهم ويسألوني عن أخباري، وهم يعرفون أنني أعرف كل أخبارهم، وأنني شاهد على حقارتهم.
آه لو تدري حسان!
لو تدري لذّة أن تمشي في شارع مرفوع الرأس، أن تقابل أيّ شخص بسيط أو هامّ جداً، دون أن تشعر بالخجل.
هناك من لا يستطيع اليوم أن يمشي خطوتين على قدميه في الشارع، بعدما كانت كل الشوارع محجوزة له. وكان يعبرها في موكب من السيارات الرسمية.
لم أقل شيئاً لحسان. وعدته فقط كمرحلة أولى أن أشتري له سيارة. قلت له: "تعال معي، واختر سيارة تناسبك. تأخذها معك من فرنسا. لا أريد أن تعيش هكذا في هذه الحالة بعد اليوم..".
فرح حسان يومها كطفل. شعرت أن ذلك كان حلمه الكبير الذي كان عاجزاً عن تحقيقه، وعاجزاً عن طلبه مني. ولكن كيف لي أن أعرف ذلك وأنا لم أزره منذ سنوات؟
عندما أذكر حسان اليوم، وحدها تلك الالتفاتة تبعث في قلبي شيئاً من السعادة، لأنني أسعدته بعض الوقت، ومنحته راحة لبضع سنوات.
سنوات.. لم أكن أتوقع أن تكون الأخيرة.
عاد حسان إلى موضوعه قال:
- هل أنت مصر حقاً على السفر غداً؟
قلت له:
- نعم.. من الأرجح أن أسافر غداً..
قال:
- إذن لا بد أن تطلب سي الشريف اليوم، لتعتذر منه. فقد يسيء تفسير موقفك.. ويأخذ على خاطره..
فكرت قليلاً فوجدته على حقّ. قلت لحسان:
- اطلب لي رقم سي الشريف لأعتذر إليه..
كنت أتوقع أن تتوقف الأمور هناك. ولكن سي الشريف راح يرحّب بي.. ويحرجني بلطفه، ويلحّ لأحضر لزيارته ولو في ذلك الحين..
قال:
- تعال إذن وتغدّ معنا اليوم.. المهم أن نراك قبل أن تسافر.. ثم يمكنك أن تقدم هديتك بنفسك للعروسين قبل أن يسافرا أيضاً هذا المساء..
لم يكن هناك من مخرج. وجدت نفسي مرة أخرى، أواجه قدري معك. أنا الذي قررت السفر على عجل، حتى أنتهي من العيش في هذه الأجواء التي كانت تدور كلها بطريقة أو بأخرى حولك.
ها أنا مرة أخرى ألبس بدلتي السوداء نفسها، أحمل لوحة توقّفت أمامها يوماً وكانت سبب كل ما حلّ بي بعد ذلك. وأذهب مع حسان إلى الغداء..
ها هما قدماي تقودانني مرة أخرى نحوك. كنت أدري أنني سألتقي بكِ هذه المرة. كان هناك حدس مسبق يشعرني أننا لن نخلف هذا الموعد اليوم.
ما الذي قاله سي الشريف ذلك اليوم؟ ما الذي قلته ومن قابلت من الناس؟ وماذا قدم لنا من أطباق على تلك السفرة.. لم أعد أذكر.
كنت أعيش لحظات حبك الأخيرة. ولم يكن يهمني شيء في تلك اللحظة، سوى أن أراك.. وأن أنتهي منك في الوقت نفسه!
ولكن.. كنت أخاف حبك. كنت أخاف أن يشتعل حبك من رماده مرة أخرى. فالحب الكبير، يظلّ مخيفاً حتى في لحظات موته.. يظلّ خطراً حتى وهو يحتضر.
وجئت..
أكثر اللحظات وجعاً، أكثر اللحظات جنوناً، أكثر اللحظات سخرية، كانت تلك التي وقفت فيها لأسلم عليكِ، وأضع على وجنتيك قبلتين بريئتين، وأنا أهنئك بالزواج، مستعملاً كل المفردات اللائقة بذلك الموقف العجيب.
كم كان يلزمني من القوة، من الصبر ومن التمثيل، لأوهم الآخرين أنني لم ألتقِ بك قبل اليوم، سوى مرّة عابرة، وأنكِ لم تكوني المرأة التي قلبت حياتي رأساً على عقب؟
المرأة التي تقاسمني سريري الفارغ منذ عدة أشهر، والتي كانت حتى البارحة.. لي!
كم كان يلزمني من التمثيل، لأهديك تلك اللوحة، دون أي تعليق إضافي، دون أية إشارة توضيحية، وكأنها لم تكن اللوحة التي بدأت بها قصتي معك منذ خمس وعشرين سنة.
وكم كنتِ مدهشة أنتِ في تمثيلك، وأنتِ تفتحينها وتلقين نظرة معجبة عليها، وكأنك ترينها لأول مرة! فلا أستطيع إلا أن أسألك يتواطؤ سري جمعنا يوماً:
هل تحبين الجسور؟
ويخيم بيننا فجأة صمت قصير، يبدو لي طويلاً كلحظة تسبق حكماً بالإعدام.. أو العفو.
قبل أن ترفعي عينيك نحوي وينزل حكمكِ عليّ:
- نعم أحبها!
كم من السعادة منحتني لحظتها في كلمتين!
شعرت أنك تبعثين لي آخر إشارة حبّ.
شعرت أنك تهديني أكثر من مشروع لوحة قادمة. أكثر من ليلة وهمية.. وأنك رغم كل شيء ستظلّين وفيّة لذاكرتنا المشتركة.. ولمدينة تواطأت معنا، ومدّت كل هذه الجسور.. لتجمعنا.
ولكن.. أكنت حبيبتي حقاً؟ في تلك اللحظة التي كان رجل آخر فيها إلى جوارك. يلتهمك بعينين لم تشبعهما ليلة حب كاملة، في تلك اللحظة التي كان فيها الحديث يدور حول المدن التي ستزورينها في شهر العسل، وكنت أنا أشيّعك بصمت، لسفرك الأخير عن قلبي..
لقد كانت تلك هزيمتك الأولى معي.. انتهى كل شيء إذن. ها أنا قابلتك أخيراً، أكان هذا اللقاء يستحق كل ذلك الانتظار، كل ذلك الألم؟
كم كان حلمي به جميلاً! وكم هو اليوم مدهش ومسطّح في واقعه! كم كان مليئاً بانتظارك، وكم هو فارغ.. موجع بحضورك!
أكانت نصف النظرة التي تبادلناها بين نظرتين، تستحق كل ذلك الوجع، كل ذلك الشوق والجنون؟
تريدين أن تقولي لي شياً، وتتلعثم الكلمات.. تتلعثم النظرات.
لقد نسيت عيناك الحديث إليّ.. ولم أعد أعرف فكّ رموزك الهيروغليفية.
فهل عدنا يومها إلى مرتبة الغرباء، دون أن ندري؟
افترقنا..
قبلتان أخيرتان على وجنتيك. نظرة.. نظرتان.. وكثير من التمثيل، وألم سري صامت.
تبادلنا جميعاً كلمات المجاملة والتهاني والشكر الأخير.
تبادلنا عناويننا، بعدما أصرّ زوجك على أن يعطيني رقم هاتفه في البيت وفي المكتب في حالة ما احتجت إلى شيء.
وانصرفنا كل بوهمه.. وقراره المسبق.
عندما عدت إلى البيت بعد ذلك، نظرت طويلاً إلى تلك البطاقة التي كنت أتحسّسها طوال الطريق بشيء من الذهول.. ومذاق ساخر للمرارة. وكأنك انتقلت معها من قلبي إلى جيبي تحت اسم ورقم هاتفي جديد.
ودون كثير من التردد.. أو التعمّق في التفكير، قرّرت أن أمزّقها فوراً، مادمت أملك القدرة على ذلك، ومادمت مصمماً على أن ينتهي كل شيء هنا في قسنطينة.. كما أردتِ يوماً، وكما أصبحت أريد أنا اليوم.
***
The End
|












 جديد مواضيع قسم الادباء والكتاب العرب
جديد مواضيع قسم الادباء والكتاب العرب










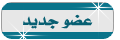





 العرض العادي
العرض العادي



